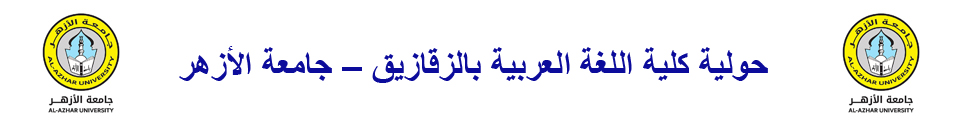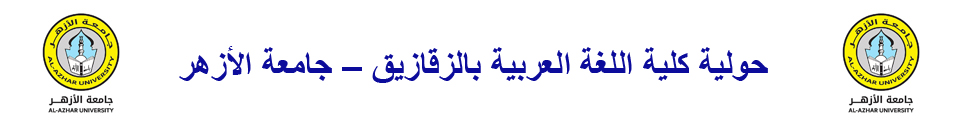حُسَام الدِّين سمير. "« عَتَبَاتُ التَّأويلِ ومُسَاءَلَةُ القَصْدِيَّة فِي مَرْجِعِيَّةِ التَّسْمِيَاتِ ومَنْطِق التَّوظِيفِ النَّحْوِيّ – ثَالِثُ ثِلَاثَةِ الكَلِم مِثَالًا »", حولية کلية اللغة العربية بالزقازيق – جامعة الأزهر, 44, 2, 2024, 1239-1328. doi: 10.21608/bfla.2024.323312.1073